المنهج في علم الاجتماع : قراءة في تصورات الكسندر جيفري و نوبيرت الياس و ميشيل كروزيه
التسلح بالحذر المعرفي امر ضروري لتأطير اي موضوع للبحث السوسيولوجي، من خلال رفض كل الاحكام الجاهزة وعدم الاستسلام للغة التبسيط و الاختزال و التجزيئ, وفق ما اشار اليه الابستيمولوجي ادغار موران ان التبسيط يعقد عملية الفهم، وهو ما يستدعي الاعتراف اولا بصعوبة الموضوع و تعقده و تداخل ابعاده ، اظافة الى اشكالية الموضوعية و صعوبة تحقيقها. لاناي بحث يتأثر بشكل كلي او جزئي بقيم و توجهات الباحث ،فالبحث الاجتماعي يصعب ان يكون محايدا، لأن كل بحث هو بحث مؤطر داخل نظرية ما و كل نظرية لها مرجعياتها الخاصة .
فاختيار الاطار النظري ليس اجراءا ثانويا في صيرورة البحث، لكنه لضرورة منهجية من اجل الحفاظ على التماسك النظري والمنطقي لموضوع البحث ،بما يقود الى منتوج فكري متماسك عبر انتاج تفسيرات أكثر قوة وملاءمة للمعطيات التجريبية المحصل عليها، وان قيمة الاطار النظري في قدرته على ضمان الانسجام داخل كل مراحل البحث تفاديا التناقض، و حفاظا على الانسجام و التناغم بين مختلف مراحل البحث .
فغياب الاطار النظري او سوء اختياره قد يقود الى الاستعانة بمفاهيم متعددة و مختلطة ،و احيانا متناقضة سواء بوعي منه او بدون وعي([1])، مما يوقع البحث في تناقضات فكرية ونظرية يمكن ان تؤثر في تفسير نتائج البحث . و ما ينتج عن من ارتباك وتناقض ستؤثر حتما على سيرورة البحث، و بالتالي على نتائجه . فتحديد الاطار النظري في مجال البحث السوسيولوجي يتيح تفاعلا ايجابيا وحوارا مستمرا بين النظرية و الواقع ، من اجل انتاج معرفة صلبة تستطيع تقديم نماذج تفسيرية للواقع المدروس ، لذا يمكن اعتبار ان الاطار النظري هو من يحدد الاطار المنهجي الخاص بالبحث .
كما أن علاقة النظرية بالبحث تتعدى مجرد التأطير الفكري إلى التأثير في المنهج المتبع في الدراسة، إذ هما ليسا منفصلان أو منعزلان عن بعضهما، فالجانب المنهجي يتبع الإطار النظري ويخضع له .
فتحقيق الانسجام الداخلي للدراسة و التوافق الخارجي حيت يفترض اساسا الاستعانة باطار نظري قادر على احترام خصوصية الظاهرة المدروسة ،و اعتماد وسائل بحث تراعي خصوصيات مجال البحث وحتى لا تبق الافكار و التصورات الموظفة بلا اثر و بدون فائدة، و غريبة عن واقعها وهو مايفيدتطبييق الواقعية السوسيولوجية لرفض كل ماهو اختزالي و تصوري([2]).
الهدف الاساسي من اي بحث هو فحص و اختبار اشكالية البحث و تفسيرها عبر ايجاد اجابات مقنعة مبررة احصائيا، من اجل تبديد كل اشكال الغموض و اللامعرفة حول الظاهرة المدروسة و ايجاذ نماذج تفسيرية لها .
اولا : الوظيفية الجديدة ورؤية الكسندر جيفري لمعالجة الظواهر الاجتماعية .
فالوظيفية الجديدة حاولت البحث و تفسير كيفية عمل المجتمعات , و كيف تؤثر المؤسسات و الانماط الثقافية في ضمان استمرارية الانساق ،لاسيما وسطمتغيرات معقدة و متسارعة في زمن العولمة بهدف تجاوز توجهات الوظيفية الكلاسيكية لبارسونز([3]) .
الوظيفية الجديدة تهدف الى دراسة الواقع وفق رؤية متعددة الابعاد، تستند الى التكامل بين مستويات التحليل القصير المدى و مستويات التحليل البعيد المدى،و ذلك من خلال فهم المجتمع في شموليته،و اتساق واقعه و بجميع الاكراهات و المحددات التي تواجه الفاعل ([4])، وهي الافكار المتضمنة في مؤلفه الاساسي الوظيفية وما بعدها، و المتوفر كنسخة الكترونية عبر محرك البحت امازون .
فالوظيفية الجديدة حاولت اعادة بناء اسس النظرية الوظيفية الكلاسيكية ، من خلال نقد اطروحات تالكوتبارسونز، و تتحدد ملامح هذا المشروع في كتاب جيفري الكسندر في كتابه : الوظيفية الجديدة و ما بعدها ([5]).
لذا سيستند البحث إلى النظرية الوظيفية الجديدة ، التى تقدم وصفاً عاماً للعلاقات المتبادلة بين الجمعية و باقي الفاعلين في محيطها العام ،وتستخدم فكرة التوازن بصفتها نقطة مرجعية وليس بصفتها شيئاً موجوداً فى الواقع ، فالتوازن هو دائماً توازن متحرك.
وقد حدد جيفري الكسندر فى مؤلفه "المنطق النظرىفى علم الاجتماع" ضرورة الأخذ فى الاعتبار ثلاث مجموعات من المتقابلات هى : التقابل بين النظرية والواقع (البعدين الميتافيزيقى والواقعي لعلم الاجتماع)،و هو ما يتيح الارتباط بينالنظرية و الواقع و الانحياز الى منطق الوصل و ليس الفصل([6])،و كذا الارتباط بين الإرادة الفردية والهيمنة الجماعية ، والفعل المعيارى والفعل الأداتى من اجل فهم الظاهرة الاجتماعية كظاهرة مركبة ومعقدة في الوقت ذاته .
لذا فقد فضل الكسندر مصطلح " علم الاجتماع متعدد الأبعاد " الذي يتضمن تناوباً بين الحرية والقهرية ويقوم هذا المنطق علي افتراضيين عامين أولهما يتصل بمشكلة الفعل ، وثانيهما يتعلق بمشكلة النظام أو بالكيفية التي يصبح بها تعدد هذه الأفعال مترابطاً ومنظما ً،و هو ما يتيح لنا فهم كيف يتم تنظيم مختلف توجهات و اراء و مصالح المنتمين للفعل الجمعوي ،و كيف يمكن تفسير دور الفاعل في بنية محكومة بمجوعة من التوازنات،و هو ما يتيح تجاوز الاتجاه البنيوي الذي جعل النسق بدون ذات فاعلة ،و كذا الاتجاه الفرادني الذي منح سلطة للفاعل دون مراعات لحتمية النسق و قهريته .
من اهم مبادئ الوظيفية الجديدة نذكر ففكرة التوازن داخل النسق الاجتماعي هو دائما توازن هش ،وهو ما يتيح فهم الواقع الاجتماعي المعقد ,و الذي يعج بالكثير من التناقضات و و اختلاف المصالح و تعدد الرهانات ، ما يولد حالة من الصراع داخل نسق الفعل الجمعوي .
الامر الذي يستدعي مقولات جديددة لفهم النسق المعقد و المتحرك عبر مقولات مثل التوازن الديناميكي، و يمكن تحدد توجهات الوظيفية الجديدة في خمسة عناصر([7]):
رفض تفاؤل بارسونز بخصوص رؤيته للحداثة و تجاوز النظرة التفاؤلية لبناء تفسير شمولي و مما يعني التخلي عن ايجاد اي تماسك كامن في العالم و يمكن تحديد ملامح الوظيفية الجديدة في التالي :
- استدماج منظور الصراع و اعتبار الصراع اداة لتحقيق التوازن .
- اعتبار التوازن يتحدد في المستويات البعيدة عكس بارسونز .
- تعدد العمليات السببية الفاعلة في العمليات الاجتماعية و هو ما يعني استحالة ايجاد مفتاح واحد لكل المقضايااستدماج مفهوم الصدفة في تحليل علاقة الفاعل بالنسق .
- نظرية متعددة مستويات التحليل .
ان اختيار الوظيفية الجديدة ينبع من ملائمتها كنظرية للجمعية كتنظيم اجتماعي و انشطتها و ادوارها التنموية وذلك للاعتبارات الاتية :
ثانيا : نظرية الترابط الاجتماعي لنوبيرت الياس NOBERT ELIAS
الترابط الاجتماعي ظهر مع السوسيولوجينوبير الياس Norbert Elias (1897-1990)([8]) في تحليله لطبيعة العلاقة المركبة بين الفرد والمجتمع ،حيت رفض وضع تعارض بين الفرد و المجتمع ،و اعتباره أن سيرورة تطور الفردانية في المجتمع الغربي ارتبطت تاريخيا بسيرورة التنشئة و التربية الاجتماعية و هكذا اعتبر أن المجتمع ليس هو حاصل وحدات فردية ،و في نفس الوقت ليس جمعا مستقلا من الأفعال الفردية ،و لكنه علاقة ترابط بين أفراد بحيث لا يمكن لأي ضمير أن يوجد من دون حضور الضمائر الأخرى .
حسب نوبير الياس ووفق مفهومه الترابط الاجتماعي أنه لا يمكن الفصل بين الفرد والمجتمع،فلا يوجد مجتمع بدون أفراد، والفرد مجرد كتلة هلامية و بلامعنى خارج المجتمع ،فالفرد والمجتمع وجهان لعملة واحدة، واعتبر ان العلاقة القائمة بين الفرد والمجتمع هي علاقة تفاعل وتأثير متبادل، فالمجتمع يمارس مفعوله في تكوين شخصية الفرد، الذي من شأنه أن يكون فاعلا اجتماعيا وليس مجرد مفعول به في المجتمع)[9]( .
نوبير الياس اعتبر ان الواقع الاجتماعي يبنى من قبل الأفراد وكل مكونات المجتمع،انطلاقا من خبرات و عادات وقيم مشتركة و مضمرة يتم نقلها عبر فعل التنشئة الاجتماعية ،أو خبرات حاضرة تستمد من الحياة اليومية أو تتكون بواسطة الهابيتوس المجتمعي([10]). وهي خبرات من طبيعة جبرية لاشعورية ولاواعية تفرض على الافراد و يتشربونها انطلاقا من المجتمع (الأسرة، والشارع، والقبيلة، المدرسة الحي المسجد الحزب النقابة الجمعية الخ بمعنى أن القيم تنتقل عند الأفراد من جيل إلى آخر، فيتمثلونها على أساس أنها معايير ومقاييس للتكيف والتطبع مع المجتمع([11]).
مفهوم نوبير الياس حول الترابط الاجتماعي يقدم تفسيرا لطبيعة الدينامية و التاثير متبادل بين الفرد والمجتمع ،فالمجتمع يمارس تأثيره في الفردبقدر ،ما يمارس الفرد تأثيره في المجتمع باختياراته وقراراته وإبداعاته.
مفهوم الترابط الاجتماعي متضمن في مؤلفه ماالسوسيولوجيا الصادر سنة 1970 و المترجم الى اللغة الفرنسية سنة 1991 أي سنة بعد وفاته.
تطبييقا لهذا المفهوم من اجل دراسة العلاقات الاجتماعية وإشكال الفعل المتبادل و بنية وشبكة العلاقات القائمة ، وتدبير السلطة داخل الجمعية كتنظيم اجتماعي و ذلك عبر :
اولا : الترابطات الداخلية للجمعية .
مفهوم الترابط الاجتماعي configuration sociale تتيح لنا امكانية اكتشاف طبيعة البنية الاجتماعية داخل الجمعية كبنيية اجتماعية لها قوانينها الخاصة ،من اجل معرفة طبيعة التفاعلات و شبكة القوى داخل الجمعية و كيفية اشتغالها داخل مجال محكوم مؤسس على التنافس،وهو ما يساعد في بناء نماذج تفسيرية لوظيفة الجمعية و ادوارها التنموية .
كما ان النظرية ستمنحنا فرصة فهم السؤال المركزي والاساسي كيف يتم تنظيم مجموعة من الافراد لانشطتهمالجماعية،وسلوكهم المشترك داخل اطار منظم وقانوني هو الجمعية ،بهدف تحقيق اهداف محددة ومعلنة ومتفق عليها مما يساعد يفيد في فهم طبيعة الحوافز المغذية للعمل والفعل الجمعوي.
ثانيا : الترابطات الخارجية للجمعية.
فالجمعية هي اطار للفعل الاجتماعي و هي فاعل سياسي واجتماعي له رهاناته و اهدافه ،مما يجعلها تنظيم يتفاعل داخل بنية اجتماعية اكبر في اطار شبكة من العلاقات المتبادلة بين اعضاء الجمعية ومنخرطيها ، فالجمعية تنظيم اجتماعي له هويته الاجتماعية وقوانييه ورهاناته و شبكة علاقاته الداخلية والخارجية .
ستساعدنا مبادى وتوجهات وأسس هذه النظرية الى فهم طبيعة الجمعية ، و مختلف الاشكال الاجتماعية التي تتيح تبادل المنافع و المصالح و طبيعة الحوافز التي تغذي العمل التطوعي والمجاني عند الفاعل الجمعوي و اعتبار الجمعية اطار للتنشئة الاجتماعية الممتدة اظافة الى البحث في طبيعة العلاقات القائمة بين الجمعية مع باقي الفاعليين في مجال اجتماعي له قواعده و بنياته الخاصة و رهاناته و مصالحه.فرؤية نوبيرتإلياستتاسس على مقاربة سوسيولوجيةتزاوج بين البعد التفسيري و البعد الفهمي، كما يزواوج بين بين التصور الشمولي وفق اسس سوسيولوجية عند إميل دوركايم والتصور الفردي عند ماكس فيبر، بين الفعل والبنية المجتمعية عبر عملية الانبناءوالهابيتوس.
وفق ما سبق ان نوبيرت الياس يعتبر ان المجتمع ينبنى و فق علاقات ترابط قائمة بين الفرد و المجتمع
وان كل فعل اجتماعي هو فعل اجتماعي بنائي يتم كعلاقة ترابط بينه و بين باقي افراد المجتمع فلا يمكن تخيل فعل خارج المجتمع و او تخيل فعل اجتماعي بدون ذات فاعلة , وهو ما يقود الى اعتماد فكرة ان أن الواقع الاجتماعي يبنى من قبل الأفراد في علاقة مع قيم و نظم المجتمع . و غالبا ما تكون القيم و العادات و المعايير المشكلة لهوية و شخصيات الافراد داخل المجتمعات ذات طبيعة لاشعورية .
كم يعتبر نوبيرت ان الافراد في بناء تصرفاتهم غالبا ما يؤسسونها على قيم وخبرات الماضي و تطلعات المستقبل . بمعنى أن القيم تنتقل عند الأفراد من جيل إلى آخر، فيتمثلونها على أساس أنها معايير ومقاييس للتكيف والتطبع مع المجتمع.وتشكل هذه المعايير والتصرفات والسلوكيات أدوات للمراقبة الذاتية والمحاسبة الشخصية. وقد استمدها الأفراد من المجتمع ومن حياتهم اليومية على حد سواء. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المجتمع يمارس تأثيره في الفرد. كما يمارس الفرد تأثيره في المجتمع باختياراته وقراراته وإبداعاته[12].
فمنهجيو نوبيرت الياس السوسيولوجية تقوم على الجمع و محاولة التوفيق بين منطق الفهم و التفسير لمقاربة الظواهر الاجتماعية وفق مقاربة سوسيولوجية : الفهم من خلال البحث عن دلالات و معاني الافعال و هو ما يجعل منهجه اقرب الى المنهج الفهمي لماكس فيبر و التي يتحدد بفهم تصرفات الأفراد السلوكية، وواستكشافدلالاتها و اهادفها ومقاصدها، و محاولة تفسبيرها من خلال البحث عن اسباب الظاهرة و نتائجها .
ففالمنهج الوسيولوجيلنوبيرت الياس يقوم على اساس البحث في مختلف العلاقات التفاعلية داخل المجتمع و التي تتحقق عبر عملية التواصل الاجتماعي ، تقوم منهجيته العلمية على الملاحظة الحسية، والاستعانة بالاختبارات الاجتماعية الكمية والكيفية، وربط التطبيق بالنظرية.
ثالثا : ميشبل كروزي نظرية الفاعل الاستراتيجي .
دواعي اختيار هذا الاتجاه هو اعتبار الجمعيات كفاعل له مصالح و اهدافه ورهاناته و شبكة علاقاته .
اختيار الاطار النظري للفاعل الاستراتيجي من اجل تاطير موضوع البحث بني على اعتبار الجمعية كفاعل سياسي و اجتماعي، له قيمته و مكانته و رهاناته في الفضاء السياسي و الاجتماعي المحلي و الوطني و الجهوي . يهتم التحليل الاستراتيجي لميشال كروزيه و المتضمن في مؤلفه L'Acteur et leSystème من اجل فهم كيفية بناء الأفعال الجماعية انطلاقاً من التصرفات الفردية و الارادية ،والعمل على تنسيقها بما يضمن الفعالية والنجاح و ايجاد الحلول لمشاكل التنظيم و الافراد([13]) .
يكون التحليل استراتيجياً عندما يحدد و يدرس سلوك الافراد كفاعلين داخل بنيات اجتماعية معينة، لا يكتفي التحليل الاستراتيجي بمعرفة السير الداخلي للتنظيمات بل يدرس كذلك اشكال ممارسة السلطة وتوزيعها داخل النسق الاجتماعي ، فكل تنظيم خاضع لقيود البنية الاجتماعية التي ينتمي اليها.
فالتحليل الاستراتيجي يهدف الى فهم كيفية بناء الأفعال الجماعية داخل التنظيمات و انطلاقا من تعدد الفاعلين و اختلاف مصالحهم ، وذلك من خلال دراسة و معاينة سلوك الفاعلين وباهدافهم العامة والخاصة و و اكراهات المحيط و كذا الموارد المتاحة لهم و رهاناتهم .
ينطلق التحليل الاستراتيجي من فكرة اساسية أن الفرد في حالة العمل لا يمكن تحديد سلوكه كلية ولا أن يتحكم فيه أو أن نتنبأ به([14]).
كل فرد داخل أي تنظيم اجتماعي له أهدافه الخاصة ،و التي تتعارض حتماً مع أهداف التنظيم. و هو ما يقود الى انتاج مجموعة من التوثرات و الصراع داخل بنية التنظيم ،لذا فاستمرارية التنظيم و استقراره مرتبط بقدرته على تدبير الصراعات الناتجة عن اختلاف المصالحبين اعضاء التنظيم . اي قدرته -التنظيم –على تدبير تناقضاته الداخلية و الخارجية .
وفق التحليل الاستراتيجي , يحتفظ كل فاعل في التنظيم بهامش من الحرية، فلا يمكن فهم صيرورة التنظيم دون التركيز على الحقيقة النسبية لحرية الفاعل. لذا يحاول الفاعل أن يجعل سلوكه غير متوقع و في الوقت ذاته أن يتوقع سلوك غيره،فالسلطة داخل التنظيم وفق منظور نظرية الفاعل الاستراتيجي تتحدد في القدرة على الاحتفاظ بمناطق ظل لا يعرفها الاخرون، و بالتالي فالحرية هي القدرة على الانفلات من ادراك الاخرين لما يخطط له الفاعل، و القدرة على الاحتفاظ بمناطق غير معروفة وغير مكشوفة للجميع .
انتقد كل من ميشيل كروزيهCrozier. M وFriedberg. E كل النظريات التي تفسر سلوك الافراد سلوكا عقلانيا، و التي تكتفي بإعطاء أعضاء التنظيم أدواراً محددة وسلوكاً عقلانياً متوقعاً، واقترح بدلاً من ذلك نظرية العقلانية المحدودة حيث يتمتع كل فاعل بعقلانية محددة و محدودة من اجل انجاز استراتيجية شخصية، يحاول من خلالها إيجاد التدابير اللازمة لتحقيق اهدافه ،و فسر كروزيه هذا المفهوم أي العقلانية المحدودة في كتابه الظاهرة البيروقراطية حيت فسرطبيعة العلاقات الاجتماعية في وكالة المحاسبة ومصنع التبغ، وبين أن كل فاعل يجتهد و يناور من اجل توسيع مجال قراره و تحصين استقلاليته ، ووضع حد لتبعيته للآخرين من خلال جعل سلوكه غير متوقعمن طرف الاخرين أي امتلاك منطقة ظل .
يعتبر كروزيه أن التنظيم عبارة عن نسق يضم سلسلة من المتغيرات، ما يصيب أحدهما يؤثر حتماً بالآخرين . بمعنى اخر فالتنظيم هو بنية متفاعلة بشكل عضوي فكل تغيير على عنصر يؤثر على باقي البنية
فالتحليل الاستراتيجي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي:
المبدأ الاول : مبدأ السلطة .
تعدالسلطة العنصر الاساسي داخل كل تنظيم ،فلا تنظيم خارج السلطة او بدون سلطة .
حسب رؤية كروزيه ان ممارسة السلطة تتم عبر وجود مبدأ التفاوض والتبادل النفعي بين الطرفين او اطراف التنظيم ، من خلال التنازل لحق طرف لطرف آخر وفق شروط محددة متوافق عليها .ومن ثم فالسلطة ليست تعسفية بقدر ما هي سلطة متوافق عليها داخل التنظيم ، أي أنها لا يمكن أن تمارس بالإكراه ، من طرف عضو ضد عضو اخر فشرعية السلطة داخل التنظيم تتحدد بمدى القبول بها من طرف باقي اعضاء التنظيم .و قد حدد كروزيه اربعة مصادر للسلطة :
- امتلاك الفاعل لكفاءة غير متوفرة لدى باقي الفاعلين .
- التحكم في مناطق الظل .
- التحكم في قنوات التواصل .
- التحكم في القواعد التنظيمية .
المبدأ الثاني: منطقة الشك([15]).
فكل وضعية تنظيمية مهما كانت تضم دوماً هامشاً من الشك ، فالذي يتحكم في هذه المنطقة يحصل على السلطة فهو يحتفظ بمنطقة لا يتحكم فيها الآخرون وتجعل سلوكه غير متوقع في نظرهم.
لتفسير العلاقة الموجودة بين السلطة والفاعل الاجتماعي ، يطرح لنا كروزيه مبدأ الشك الذي يستغله الفاعل الإستراتيجي كأرضية لبناء نوع من العنف / السلطة المقبولة اتجاه الاخرين ،وذلك في محاولة إجباره على الإلتزام بقواعد "العمل ، النظام ".
فمن يستطيع التحكم في منطقة الشك أو الإرتياب بحسب كروزيه ،هو الذي له القدرة على ممارسة الرقابة والنفوذ والسلطة على الآخرين ، بما يخدم مصالحه وبما يجعل الآخرين تابعين له في قراراته .فبقدر مؤهلاته وإمكانياته بقدر ما يتحكم في تلك المنطقة التي تمكنه من اكتساب قوة غير معلنة و خفية / المصدر الاول للسلطة .
لذا فتحقيق الاستقلالية رهين ببناء مناطق ظل لا يستطيع الاخرون التحكم فيها .
المبدأ الثالث: نسق الفعل الملموس.
نسق الفعل الملموس هو نتيجة مختلف الاستراتيجيات التي يمارسها الفاعلون داخل أي تنظيم اجتماعي .و هو ليس بالضرورة خاضع للرسمية و التنظيم الرسمي ، إنما هي تلك الاستراتيجيات المنظمة و المرتبة بين الفاعلين في علاقاتهم التبادلية تظهر فيها المصلحة و التنافر و الصراع .
يمكن استخلاص بعض خطوات هذا المنهج وهي خمسة خطوات لهذا التحليل هي :
1 – تحديد الإشكاليات و الرهانات المطروحة في التنظيم .
2 – استنتاج من هم الفاعلون المرتبطون بها .
3 – دراسة كل فاعل من حيت طبيعته وخصائصه وهامش حركته ، مدى تحكمه بمنطقة الشك)
4 – استخلاص و استنتاج الاستراتيجيات التي يظهرها أو يتبناها الفاعل او الفاعلون داخل التنظيم الاجتماعي .
5 – دراسة التفاعل بين مختلف الاستراتيجيات المستنبطة من نسق الفعل .
و بعد هذه المرحلة يتم اكتشاف نسق الفعل العام،و التوصل الى مختلف الاستراتيجيات الموجودة ، و بالتالي بناء نما ذج تخطيطية لتوضيح العملية التي تساعدنا على فهم طبيعة ووظيفة النسق و فاعليته.
[1]لايدر،ديريك، قضاياالتنظيرفي البحث الإجتماعي،ترجمةعدلي السمري،،القاهرة،. 2000 ص 118
[2]حسن المجاهيد المرجع السابق ص 16
[3]شكلت كتابات مثل (الخيال السوسيولوجي )و (الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي ) انتقادا صريحا و قويا للوظيفية بارسونز، وهو نفس الامر مع افكار و تصورات ماركيز لاسيما في مؤلفه الانسان ذو البعد الواحد و صفوة القوة حيت ظهر بوضوح اوجه القصور الذي تعانيه البارسونية في فهم و تفسير الواقع الاجتماعي و عدم قدرتها على استيعاب التغيرات الجديدة ، لاسيّما على مستوى الطبقة الوسطى ، و تفاقم الصراع ، و تمركز القوة في يد الصفوات الثلاث السياسية و الاقتصادية و العسكرية ، و ما قابله من غليان في الشارع قادته شرائح جديدة إظافة للطبقة العمالية هي شرائح الطلاب الجامعيين و القوة السوداء و الحركات النسوية و شرائح أخرى من دعاة السلام و نبذ
لذا يمكن القول ان هناك اتجهان كبيران في النظريات الاجتماعية , نظرية تهتم بالوحدات الكبرى و بالبناء الاجتماعي و نظريات علم اجتماع الوحدات الصغرى و تهتم بالفرد وقيمه و سلوكه ،. و عليه بات موضوع علم الاجتماع يدور في ثنائيات مثل الذّات / الموضوع ، الفرد /المجتمع ، الفعل/ البنية ، الفاعل / البناء ، الطوعية /الجبرية .
هذه التتائية الحادة سيعمل السوسيولوجيالامؤريكيجيفري ألكسندر تلميذ بارسونز على تجاوزه من خلال نظريته الوظيفية الجديدة ، و التي تأخذ بعين الاعتبار وجود صراع في المجتمع ، كما تولي اهتماما بالفرد الفاعل في المجتمع ، والربط بين الفعل و البنية ، الفرد و المجتمع ، الفاعل و البناء و اصبح الاهتمام بقضايا كانت خارج اهتمامات بارسونز مثل الهوية ، الجريمة و العنف و الاٍرهاب ، التعددية الثقافية ، التدهور البيئي ، العولمة ..الخ ، هذه القضايا و غيرها هي التي باتت تشكل اليوم محور اهتمام علم الاجتماع الجديد
[4]https://www.amazon.fr/Neofunctionalism-After-Collected-Alexander-1998-02-04/dp/B01K2JSJRY/ref=asap_bc?ie=UTF8
[5]كريب ايان 1999 النظرية الاجتماعية من بارسونز الى هابرماس محمد حسن غلوم عالم المعرفة العدد 244
[6]فوزي بوحريص / في مناقشته لاطروحة الباحث مروان في عنوان
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_C._Alexander مقال منشوربموقعوكبييديا على الرابط16
Neofunctionalism
In sociology, neofunctionalism represents a revival of the thought of Talcott Parsons by Jeffrey C. Alexander, who sees neofunctionalism as having 5 central tendencies:
to create a form of functionalism that is multidimensional and includes micro as well as macro levels of analysis
to push functionalism to the left and reject Parsons’s optimism about modernity
to argue for an implicit democratic thrust in functional analysis
to incorporate a conflict orientation, and
to emphasize uncertainty and interactional creativity.
While Parsons consistently viewed actors as analytical concepts, Alexander defines action as the movement of concrete, living, breathing persons as they make their way through time and space. In addition he argues that every action contains a dimension of free will, by which he is expanding functionalism to include some of the concerns of symbolic interactionism.
[8]يعد نوربرت إلياس (Norbert Elias) من أهم السوسيولوجيين الألمان، ولد سنة 1897م في بريسلو (Breslau) بألمانيا، وتوفي سنة 1990م بأمستردام بهولندا. من اهم مؤلفاته : اولا : حول سيرورة الحضارة ويتضمن ثلاثة اجزاء حضارة القيم، وديناميكية الغربومجتمع البلاط . ثانيا: السوسيولوجيا والتاريخ، ثالثا : وما السوسيولوجيا؟[3]، رابعا : ومجتمع الأفراد خامسا ، والرياضة والحضارة .
[9]https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Société_des_individus
[10] ويُعرّف الهابيتوس بأنه نسق من الاستعدادات المكتسبة التي تحدد سلوك الفرد ونظرته إلى نفسه وإلى العالم الذي يكتنفه، وهو أشبه ما يكون بطبع الفرد أو بالعقلية التي تسود في الجماعة لتشكل منطق رؤيتها للكون والعالم. ووفقا لهذا التصور يعد “الهابيتوس” جوهر الشخصية والبنية الذهنية المولدة للسلوك والنظر والعمل، وهو في جوهره نتاج لعملية استبطان مستمرة ودائمة لشروط الحياة ومعطياتها عبر مختلف مراحل الوجود بالنسبة للفرد والمجتمع.
[11]https://sociologie.revues.org/923
[12]http://www.almothaqaf.com/index.php/idea2015/890347.htmlجميل حمدواي : نوبيرت الياس السوسيولوجي المنسي منشور على الموقع
[13]Michel Crozier, Erhard Friedberg L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective Éditions du Seuil, 1981. Première parution en 1977, dans la collection "Sociologie politique"; rééd. Points, collections Essais, 2015
[14]ا عبد القادر خريبش ا لتحليل الاستراتيجي عند ميشال كروزيي: مجلة جامعة دمشق العدد الاول والثاني ص 576
[15]المرجع السابق ص 587

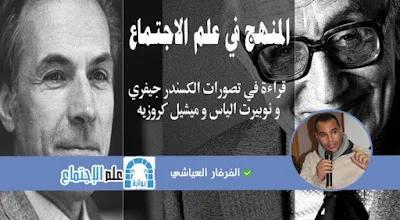

مرحبا بك في بوابة علم الاجتماع
يسعدنا تلقي تعليقاتكم وسعداء بتواجدكم معنا على البوابة